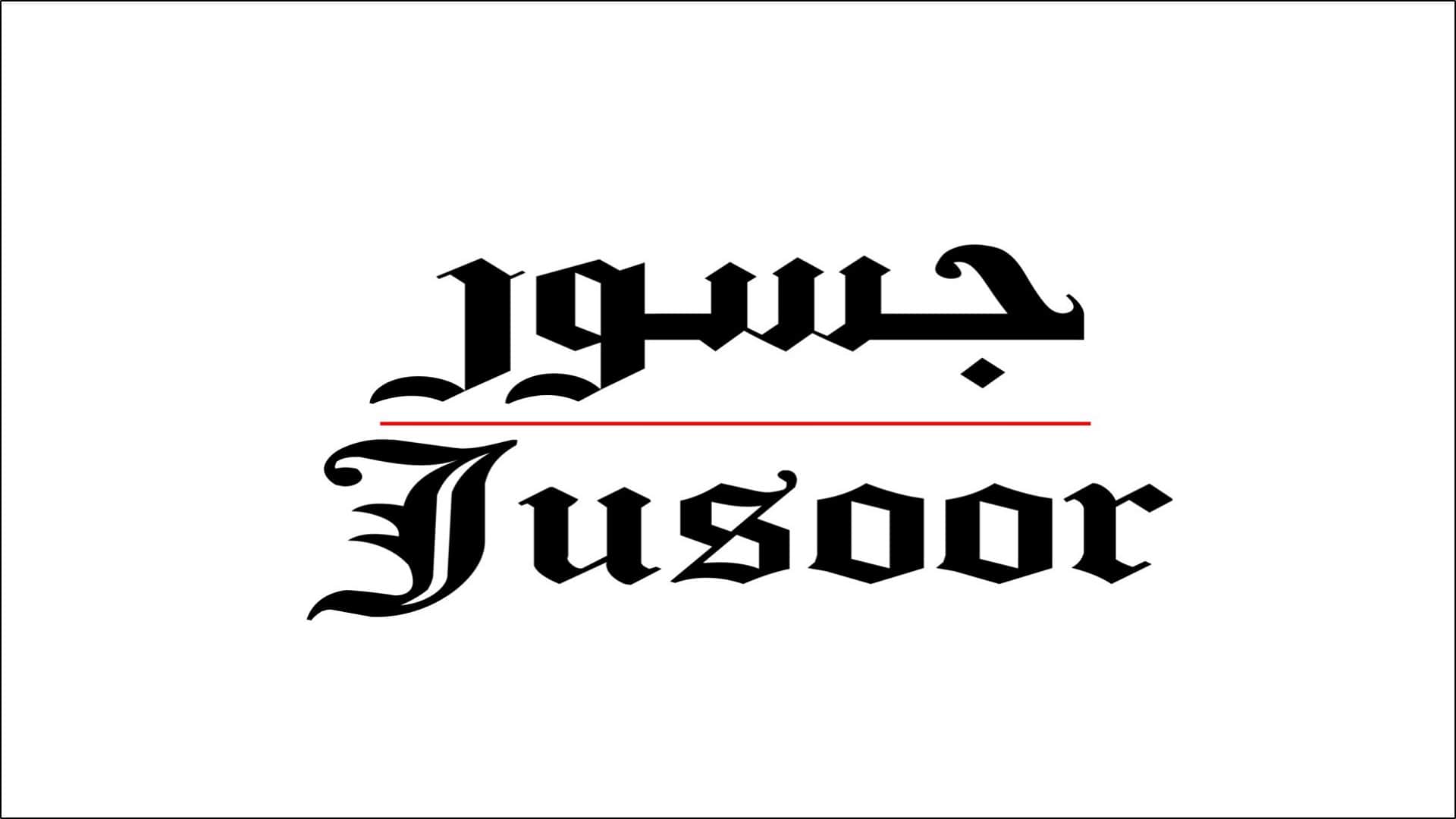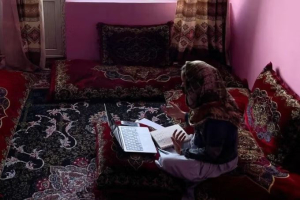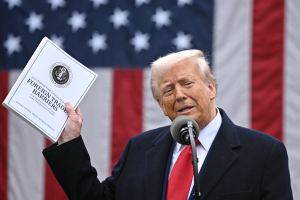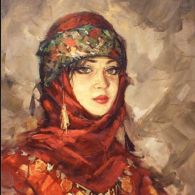أزمة تتجاوز السدود.. انخفاض منسوب سد بوكان يهدد سلاسل الحياة في إيران والعراق
أزمة تتجاوز السدود.. انخفاض منسوب سد بوكان يهدد سلاسل الحياة في إيران والعراق
يدق سد بوكان في غرب إيران ناقوس خطر غير مسبوق منذ أكثر من أربعة عقود، وتشير الأرقام الرسمية التي تخرج تباعاً من المحافظات المتأثرة، إلى تراجع حاد في المخزون المائي، وإلى أثر مباشر على أمن مياه الشرب والزراعة والطاقة لملايين السكان في شمال غرب إيران، مع ارتدادات ملموسة على مدن ومحافظات في العراق تعتمد على روافد دجلة واحتياطيات سد دوكان.
وفي حين تتشابك العوامل المناخية مع خيارات إدارة المورد المائي، تتزايد المخاوف من تحوّل الأزمة إلى مسار طويل الأمد يعيد رسم خريطة السكن والرزق في الإقليم كله.
السد الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى قرابة 900 مليون متر مكعب، لا يحتوي اليوم إلا على نحو 180 مليون متر مكعب، في حين لا تتجاوز الكمية القابلة للاستخدام الفعلي ثمانين مليون متر مكعب، بحسب تقديرات محلية مطابقة لما رصده مسؤولون في أذربيجان الشرقية.
وهذا التراجع ترجم تحذيراً صريحاً بأن احتياطي مياه الشرب لمدينة تبريز قد يكفي لنحو خمسة وسبعين يوماً فقط إذا استمر الهبوط بالمعدل نفسه، ما دفع السلطات إلى الحديث عن خطط تقنين وتدابير طارئة للحفاظ على الإمدادات الأساسية وفق "كوردستان 24".
خريطة هيدرولوجية يجب توضيحها
سد بوكان مشيّد على نهر زرينة رود ضمن حوض بحيرة أرومية، وهو يغذي -تاريخياً- جزءاً كبيراً من احتياجات تبريز ومحيطها، أما أزمة تدفقات المياه العابرة إلى العراق فترتبط بشكل رئيسي بتراجع الإيرادات في أنهار حدودية أخرى تنبع من إيران مثل الزاب الصغير والسيروان، حيث أسهمت موجات الجفاف وتوسع إنشاء السدود والتحويلات المائية في تقليص الواردات نحو العراق.
هذا التمييز مهم لفهم أن الجفاف والطلب المتزايد على المياه في الإقليم يصنعان ضغطاً متزامناً على أحواض مختلفة، حتى لو لم تكن مرتبطة مباشرة ببعضها داخل الحوض نفسه.
في القرى المحيطة، تبدو الأزمة ملموسة في تفاصيل الحياة اليومية، حيث كانت حقول تُسقى من قنوات السد باتت قاحلة، ومربو الأسماك خسروا جزءاً من مصادر رزقهم مع نفوق جماعي في أقفاص التربية، ومزارعون صاروا يواجهون خيارات قاسية بين تقليص زراعاتهم أو ترك أراضيهم موسماً كاملاً.
وفي المدن، تتكاثر الشكاوى من تراجع ضغط المياه وتغيّر جداول الضخ، في حين يخشى المسؤولون من أن تؤدي أي موجات جفاف طويلة إلى موجات نزوح داخلي وبطالة موسمية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية.
عوامل مركبة وراء التدهور
يتجمع في هذه الأزمة خليط معقد من العوامل.. المناخ القاسي وتواتر سنوات الجفاف قلصا الهطول والتغذية الطبيعية للخزانات، وفي المقابل، كبّلت السياسات المائية القديمة والجديدة قدرة المنظومة على التكيف، من الاعتماد المفرط على السدود والتحويلات بين الأحواض، إلى ضعف الاستثمار في كفاءة الري وإدارة الطلب الحضري، مروراً بالاستنزاف الكبير للمياه الجوفية، والنتيجة أن أي موسم مطير متوسط لم يعد كافياً لتصحيح اختلالات تراكمت خلال سنوات، ما يفاقم هشاشة الأمن المائي في الشمال الغربي الإيراني وفي الأحواض العابرة للحدود إلى العراق.
في شمال العراق، هبط منسوب بحيرة دوكان إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقدين، مع مخزون يقارب ملياراً وستمئة مليون متر مكعب من أصل سبعة مليارات، أي نحو 24% فقط من طاقته التخزينية، بحسب إدارة السد، وترتب على ذلك تشديد تقنين المياه في السليمانية وكركوك ومناطق مجاورة، ما يضغط على مياه الشرب والري ويهدد موسم الزراعة الصيفي، في حين تُظهر صور الأقمار الصناعية تقلصاً لافتاً في مساحة سطح البحيرة، وتربط السلطات الكردية هذا التراجع بقلة الهطول وتوسع السدود والتحويلات في دول المنبع، وعلى رأسها إيران وتركيا، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي.
حقوق الإنسان والقانون الدولي
تتعامل المنظمات الحقوقية الدولية مع المياه بوصفها حقاً أصيلاً، فالجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 2010 الحق في مياه شرب مأمونة وصرف صحي للجميع، فيما كرّس مجلس حقوق الإنسان مبادئ هذا الحق والتزامات الدول حيال عدم التمييز وضمان الإتاحة والقدرة على التحمل، وفي حالة الأحواض المشتركة، تطرح اتفاقية الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود إطاراً للتعاون وتقاسم البيانات وتقليل الضرر، وقد انضم العراق إليها عام 2023 في خطوة تعكس حاجته إلى تعاون أوسع مع دول الجوار لتأمين تدفقات مستقرة.
وإلى جانب الأطر الأممية، وثّقت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش وأمنستي أن القلاقل الاجتماعية في إيران خلال أعوام الجفاف ارتبطت مباشرة بشح المياه وسوء إدارتها، داعية إلى إصلاحات شفافة وحماية الحق في الاحتجاج السلمي بشأن الموارد.
على المستوى الإنساني، تتجمع مؤشرات الخطر في مسارين متلازمين الأول أمني غذائي داخل إيران، إذ يؤدي تقنين مياه الري إلى تقليص مساحات القمح والخضراوات والمحاصيل البستانية في محافظات تشكل الشمال الغربي فيها سلة غذاء مهمة، ما ينعكس على الأسعار وفرص العمل الموسمية، والثاني في العراق حيث يعيش نحو أربعة ملايين شخص أسفل بحيرة دوكان على تدفقات الزاب الصغير، هؤلاء يواجهون بالفعل جداول توزيع أكثر صرامة في مياه الشرب، وتحديات كبرى لمربي الماشية والمزارعين، وتكاليف مضاعفة لتشغيل الآبار والمضخات أو شراء المياه المنقولة بالصهاريج.
ماذا تفعل الحكومات الآن
ثمة مسارات عملية يمكن الشروع فيها دون تأخير، داخلياً من خلال توسيع برامج تقليل الفاقد في الشبكات الحضرية، وتعديل جداول الضخ بما يوازن بين الشرب والصناعة والري، ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة عبر التحول إلى الري بالضغط والمحاور، وإعادة توجيه الدعم بعيداً عن الزراعات الشرهة للمياه في الأحواض المتأزمة، وفنياً، الاستثمار في إعادة استخدام المياه المعالجة للصناعة والري غير الغذائي، وتوسيع عمليات حصاد مياه الأمطار والتخزين الصغير في القرى. وإداريا، اعتماد إدارة تشاركية على مستوى الحوض، ونشر بيانات المنسوب والتدفقات آنيا لرفع الشفافية والثقة العامة.
على خط الأحواض المشتركة، يحتاج العراق وإيران إلى منصات دائمة لتبادل البيانات الهيدرولوجية والإنذار المبكر والتنسيق الموسمي على الإطلاقات المائية بما يراعي مقتضيات الزراعة ومياه الشرب في الجانبين، ويوفر الإطار المتاح في اتفاقية المجاري المائية العابرة للحدود مرجعية، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية وتفويض فني واضح، ومن شأن اتفاقات تشغيل مرنة خلال سنوات الشح أن تقلل الضرر المتبادل وتوفر حدّا أدنى من الاستقرار للتجمعات السكانية الزراعية، وتحد من اللجوء إلى إجراءات أحادية تضاعف آثار الجفاف.
إشارات إنذار يجب عدم إغفالها
تراجع المنسوب إلى مستويات تهدد إمدادات تبريز على المدى القريب، واقتراب مخزون دوكان من ربع طاقته الاستيعابية، وتزامن ذلك مع توقعات مواسم مطرية متذبذبة، كلها مؤشرات إلى نافذة زمنية ضيقة لإجراءات تصحيحية، والمعالجة المؤقتة عبر التقنين وحده ستبقى مكلفة اجتماعياً ما لم ترافقها سياسات لإدارة الطلب وتحسين الكفاءة ومكافحة الهدر، ومعايير شفافة في التحويلات بين الأحواض داخل إيران، وتفاهمات تشغيلية مع دول الجوار في الأحواض المشتركة داخل العراق.
أُنشئ سد بوكان على نهر زرينة رود ضمن حوض بحيرة أرومية، ويُعرف أيضا بسد الشهيد كاظمي. لعب دوراً محورياً في تزويد تبريز ومدن مجاورة بمياه الشرب منذ عقود، إلى جانب تغذية الزراعة وتوليد الطاقة، يتزامن انخفاض منسوبه مع سنوات جفاف متكررة ومع توسع استعمالات المياه في الإقليم، ومع أزمة أوسع في بحيرة أرومية التي فقدت قسماً كبيراً من مساحتها خلال العقد الماضي، على الضفة الأخرى من الحدود، يعتمد شمال العراق على روافد دجلة، وبينها الزاب الصغير الذي يخزن مياهه سد دوكان المقام منذ خمسينيات القرن الماضي، تراجع مخزونه إلى نحو أربعة وعشرين في المئة هذا الصيف دفع السلطات إلى تقنين قاسٍ للمياه في السليمانية وكركوك.
ويُعد الحق في المياه حقا معترفا به دوليا بقرارات أممية، في حين يوفّر انضمام العراق إلى اتفاقية المجاري المائية العابرة للحدود منصة قانونية وفنية لبناء ترتيبات تشغيلية وتشاركية مع دول المنبع، ومنها إيران، للحد من الضرر خلال مواسم الشح وتثبيت قواعد تقاسم المنفعة.